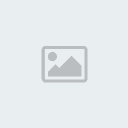القـرآن
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة:104)
التفسير:
.{ 104 } قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }: تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المنادَى؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص في الإيمان؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: { يا أيها الذين آمنوا } فأرعها سمعك . يعني استمع لها .؛ فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه"(159). وهذه الآية من النهي: { لا تقولوا راعنا} يعني لا تقولوا عند مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم راعنا؛ و{ راعنا } من المراعاة؛ وهي العناية بالشيء، والمحافظة عليه؛ وكان الصحابة إذا أرادوا أن يتكلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: "يا رسول الله، راعنا" ؛ وكان اليهود يقولون: "يا محمد، راعنا"؛ لكن اليهود يريدون بها معنى سيئاً؛ يريدون "راعنا" اسم فاعل من الرعونة؛ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم راعن؛ ومعنى "الرعونة" الحمق، والهوج؛ لكن لما كان اللفظ واحداً وهو محتمل للمعنيين نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوه تأدباً، وابتعاداً عن سوء الظن؛ ولأن من الناس من يتظاهر بالإيمان . مثل المنافقين . فربما يقول: "راعنا" وهو يريد ما أرادت اليهود؛ فلهذا نُهي المسلمون عن ذلك..
قوله تعالى: { وقولوا انظرنا } يعني إذا أردتم من الرسول أن ينتظركم فلا تقولوا: { راعنا }؛ ولكن قولوا: { انظرنا }: فعل طلب؛ و"النظر" هنا بمعنى الانتظار، كما في قوله تعالى: {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام} [البقرة: 210] ، أي ما ينتظر هؤلاء..
قوله تعالى: { واسمعوا } فعل أمر من السمع بمعنى الاستجابة؛ أي اسمعوا سماع استجابة، وقبول، كما قال تعالى: {ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون} [الأنفال: 21] يعني اسمعوا ما تؤمرون به فافعلوه، وما تنهون عنه فاتركوه..
قوله تعالى: { وللكافرين عذاب أليم }؛ المراد بـ "الكافرين" هنا اليهود؛ و{ عذاب } بمعنى عقوبة؛ و{ أليم } بمعنى مؤلم..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: أنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ؛ يعني أن يُتجنب الألفاظ التي توهم سبًّا، وشتماً؛ لقوله تعالى: { لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا..
.2 ومنها: أن الإيمان مقتضٍ لكل الأخلاق الفاضلة؛ لأن مراعاة الأدب في اللفظ من الأخلاق الفاضلة..
.3 ومنها: أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان..
.4 ومنها: أنه ينبغي لمن نهى عن شيء أن يدل الناس على بدله المباح؛ فلا ينهاهم، ويجعلهم في حيرة..
.5 ومنها: وجوب الانقياد لأمر الله ورسوله؛ لقوله تعالى: ( واسمعوا )
.6 ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله، وأنها من أعمال الكافرين؛ لقوله تعالى: (وللكافرين عذاب أليم )
القـرآن
)مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (البقرة:105)
التفسير:
.{ 105 } قوله تعالى: { ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين }؛ { ما } نافية؛ و{ يود } بمعنى يحب؛ و "الود" خالص المحبة؛ و{ مِن } هنا لبيان الجنس؛ وليست للتبعيض؛ وعليه يصير المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار؛ { ولا المشركين } معطوفة على قوله تعالى: { من أهل الكتاب } يعني: ما يود الذين كفروا من هؤلاء، ولا هؤلاء؛ ولهذا قال تعالى: { ولا المشركين }؛ لأنها لو كانت معطوفة على { الذين كفروا } لكانت بالرفع؛ فعلى هذا تكون { من } لبيان الجنس؛ أي الذين كفروا من هذا الصنف . الذين هم أهل الكتاب؛ وكذلك من المشركين..
قوله تعالى: { أن ينزل عليكم من خير من ربكم }: { أن ينزل } مفعول { يود } يعني: ما يودون تنزيل خير؛ وقوله تعالى: { من خير }: { مِن } زائدة إعراباً؛ و "الخير" هنا يشمل خير الدنيا، والآخرة، القليل والكثير؛ لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من اليهود، والنصارى، ومن المشركين أن يمنعوا القطر عن المسلمين لفعلوا؛ لأنهم ما يودون أن ينزل علينا أيّ خير؛ ولو تمكنوا أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا؛ وهذا ليس خاصاً بأهل الكتاب والمشركين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بل هو عام؛ ولهذا جاء بصيغة المضارع: { ما يود }؛ وهو دال على الاستمرار..
وقوله تعالى: { ينزَّل } بتشديد الزاي؛ وفي قراءة بدون تشديد؛ والفرق بينهما أن "التنزيل" : هو إنزاله شيئاً فشيئاً؛ وأما "الإنزال" : فهو إنزاله جملة واحدة؛ هذا هو الأصل؛ فهم لا يودون هذا، ولا هذا: لا أن ينزل علينا الخير جملة واحدة؛ ولا أن ينزل شيئاً فشيئاً..
قوله تعالى: { والله يختص برحمته من يشاء }؛ "يختص" تستعمل لازمة، ومتعدية؛ فإن كانت لازمة فإن { مَن } فاعل { يختص }؛ والمعنى على هذا: ينفرد برحمته من يشاء؛ كما تقول: اختصصت بهذا الشيء: أي انفردت به؛ وإن كانت متعدية فهي بمعنى: يخص برحمته من يشاء؛ وعلى هذا فتكون { مَن } مفعولاً به لـ{ يختص }؛ وعلى كلا الوجهين المعنى واحد: أي أن الله عز وجل يخص برحمته من يشاء؛ فيختص بها..
وقوله تعالى: { برحمته } يشمل رحمة الدين، والدنيا؛ ومن ذلك رحمة الله بإنزال هذا الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو من رحمة الله عليه، وعلينا، كما قال تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} (الأنبياء: 107).
وقوله تعالى: { من يشاء } هذا مقرون بالحكمة؛ يعني اختصاصه بالرحمة لمن يشاء مبني على حكمته سبحانه وتعالى؛ فمن اقتضت حكمته ألا يختصه بالرحمة لم يرحمه..
قوله تعالى: { والله ذو الفضل } أي ذو العطاء الزائد عما تتعلق به الضرورة؛ و{ العظيم } أي الواسع الكثير الكبير؛ فالعِظم هنا يعود إلى الكمية، وإلى الكيفية..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين؛ لأنه تعالى ذكر صنفين ينتظمان جميع الأصناف: أهل الكتاب . وهم اليهود، والنصارى .؛ والمشركين . وهم كل أصحاب الأوثان .؛ فكل هؤلاء أعداء للمسلمين؛ لأنهم لا يودون الخير للمسلمين..
.2 ومنها: أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر عن اليهود، والنصارى، والمشركين، ونتخذهم أعداءً، وأن نعلم أنهم بجميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين..
.3 ومنها: أن هؤلاء الكفار يودون أن يمنعوا عن المسلمين التقدم..
.4 ومنها: أنه يحرم على المسلمين أن يُوَلُّوا هؤلاء الكفار أيّ قيادة؛ لأنهم ما داموا لا يودون لنا الخير فلن يقودونا لأيّ خير مهما كان الأمر؛ ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين لا في تخطيط، ولا في نظام، ولا في أي شيء؛ بل يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين، وتحت تدبيرهم ما أمكن؛ وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت سلطتنا؛ لأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض عن المسلمين لفعلوا؛ إذاً فيجب علينا الحذر من مخططاتهم، وأن نكون دائماً على سوء ظن بهم؛ لأن إحسان الظن بهم في غير محله؛ وإنما يحمل عليه الذل، وضعف الشخصية، والخور، والجبن؛ ولهذا قال تعالى: { ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم }؛ وهي شاملة لخير الدنيا، والآخرة؛ فاليهود حسدوا المسلمين لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونزل عليهم هذا الكتاب..
.5 ومن فوائد الآية: أن خير الله لا يجلبه ودّ وادّ، ولا يرده كراهة كاره؛ لقوله تعالى: { والله يختص برحمته من يشاء }؛ فلا يمكن لهؤلاء اليهود، والنصارى، والمشركين أن يمنعوا فضل الله علينا؛ وعلى هذا جاء الحديث الصحيح: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك(160)" ..
.6 . ومنها: أن الإنسان الذي لا يود الخير للمسلمين فيه شبه باليهود، والنصارى؛ لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم..
.7 ومنها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: { من يشاء }؛ ومشيئته تعالى عامة في كل شيء سواء كان من أفعاله، أو من أفعال عباده؛ لقوله تعالى: {ولو شاء الله ما فعلوه} [الأنعام: 137] ، وقوله تعالى: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين} [التكوير: 29] ؛ وأما ما يتعلق بأفعاله تعالى فالأمثلة عليه كثيرة، كقوله تعالى: {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها} [السجدة: 13] ، وقوله تعالى: {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد} [فاطر: 16] ، وقوله تعالى: { والله يفعل ما يشاء }، وغير ذلك من الآية..
.8 ومن فوائد الآية: إثبات الرحمة لله؛ لقوله تعالى: ( برحمته )
.9 ومنها: إثبات الإرادة لله؛ لقوله تعالى: { يختص }؛ لأن التخصيص يدل على الإرادة..
.10 ومنها: إثبات الفضل لله؛ لقوله تعالى: ( ذو الفضل )
.11 ومنها: إثبات أن فضله ليس كفضل غيره؛ ففضل غيره محدود؛ وأما فضل الله ففضل عظيم لا حدود له؛ فإن الله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم؛ ومن فضله تبارك وتعالى أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة كثيرة ما جعلها لأحد سواها؛ منها ما جاء في حديث جابر في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ؛ وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة"(161) ..
تــنــبــيــه:.
لا يعارض هذه الآية قوله تعالى: {لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون} [المائدة: 82] ؛ لأن هذه الآية في صنف معين من النصارى: وهم الذين منهم القسيسون، والرهبان الذين من صفاتهم أنهم لا يستكبرون؛ فإذا وجد هذا الصنف في عهد الرسول، أو بعده انطبقت عليه الآية؛ لكن اختلفت حال النصارى منذ زمن بعيد؛ نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم، حتى يعرفوا حقيقة عداوة النصارى، وغيرهم من أهل الكفر، فيعدوا لهم العدة..
القـرآن
)مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة:106)
التفسير:
.{ 106 } قوله تعالى: { ما ننسخ من آية أو ننسها } فيها ثلاث قراءات؛ الأولى: بفتح النون الأولى في { نَنسخ }؛ وضمها في { نُنسها } بدون همز؛ والثانية: بفتح النون الأولى في { نَنسخ }؛ وفتحها في { نَنسأها } مع الهمز؛ والثالثة بضم النون الأولى في { نُنسخ }؛ وضمها في { نُنسها } بدون همز..
قوله تعالى: { ما ننسخ من آية... }؛ { ما }: شرطية؛ وهي اسم شرط جازم يجزم فعلين؛ الأول: فعل الشرط: { ننسخ }؛ والثاني: جوابه: { نأت }؛ وأما قوله تعالى: { أو ننسها } فهي معطوفة على ( ننسخ )
وقوله تعالى: { ننسخ من آية أو ننسها } بضمير الجمع للتعظيم؛ وليس للتعدد؛ لأن الله واحد؛ و"النسخ" معناه في اللغة: الإزالة؛ أو ما يشبه النقل؛ فالأول كقولهم: "نسخت الشمس الظل" يعني أزالته؛ والثاني كقولهم: "نسخت الكتاب"؛ إذ ناسخ الكتاب لم يزله، ولم ينقله؛ وإنما نقش حروفه، وكلماته؛ لأنه لو كان "نسخ الكتاب" يعني نقله كان إذا نسخته انمحت حروفه من الأول؛ وليس الأمر كذلك؛ أما في الشرع: فإنه رفع حكم دليل شرعي، أو لفظه، بدليل شرعي؛ و{ مِن } لبيان الجنس؛ لأن { ما } اسم شرط جازم مبهم؛ والمراد بـ "الآية" الآية الشرعية؛ لأنها محل النسخ الذي به الأمر والنهي دون الآية الكونية..
وقوله: { ننسها } من النسيان؛ وهو ذهول القلب عن معلوم؛ وأما { ننسأها } فهو من "النسأ"؛ وهو التأخير؛ ومعناه: تأخير الحكم، أو تأخير الإنزال؛ أي أن الله يؤخر إنزالها، فتكون الآية لم تنزل بعد؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلها بغيرها؛ وأما على قراءة { ننسها } فهو من النسيان؛ بمعنى نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينساها، كما في قوله تعالى: {سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله} [الأعلى: 6 . 7] ؛ والمراد به هنا رفع الآية؛ وليس مجرد النسيان؛ لأن مجرد النسيان لا يقتضي النسخ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآية؛ وهي باقية كما في الحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه فقال له رجل: تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلَّا أذكرتنيها(162)" ..
قوله تعالى: { نأت بخير منها } هو جواب الشرط؛ والخيرية هنا بالنسبة للمكلف؛ ووجه الخيرية . كما يقول العلماء . أن النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب؛ وإن كان إلى أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر؛ وإن كان بالمماثل فالخيرية باستسلام العبد لأحكام الله عز وجل، وتمام انقياده لها، كما قال تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه} [البقرة: 143] ..
قوله تعالى: { أو مثلها } أي نأتي بمثلها..
قوله تعالى: { ألم تعلم } الهمزة هنا للاستفهام؛ والمراد به التقرير؛ وكلما جاءت على هذه الصيغة فالاستفهام فيها للتقرير، مثل: {ألم نشرح لك صدرك} [الشرح: 1] ؛ فقوله تعالى: { ألم تعلم } يقرر الله المخاطَب . سواء قلنا: إنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أو كل من يتأتى خطابه . بالاستفهام بأنه يعلم { أن الله على كل شيء قدير }؛ يعني أنك قد علمت قدرة الله على كل شيء؛ ومنها القدرة على النسخ..
وقوله تعالى: { قدير }: لما أريد بها الوصف جاءت على صيغة "فعيل"؛ لكن إذا أريد بها الفعل تكون بصيغة "الفاعل"، كما في قوله تعالى: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم} [الأنعام: 65] ؛ و "القدرة" صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز؛ و"القوة" صفة تقوم بالقوي بحيث يفعل الفعل بلا ضعف؛ إذاً المقابل للقدرة: العجز؛ لقوله تعالى: {وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً} [فاطر: 44] ؛ والمقابل للقوة: الضعف، قال تعالى: {الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة} [الروم: 54] ؛ والفرق الثاني بينهما: أن "القوة" يوصف بها من له إرادة، وما ليس له إرادة؛ فيقال: رجل قوي؛ وحديد قوي؛ وأما "القدرة" فلا يوصف بها إلا ذو إرادة؛ فلا يقال: حديد قادر..
تــنــبــيــه:.
من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول الجزء الثاني تجد أن كل الآيات توطئة لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ ولهذا تجد الآيات بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: ثبوت النسخ، وأنه جائز عقلاً، وواقع شرعاً؛ وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني؛ فإنه زعم أن النسخ مستحيل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب التخصيص؛ وليس من باب النسخ؛ وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه؛ بل أمدها إلى يوم القيامة؛ فإذا نُسِخت فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ . أي أخرجناه من الحكم .؛ فمثلاً: وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجباً إلى يوم القيامة شاملاً لجميع الأزمان؛ فلما نُسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصاً؛ وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافاً لفظياً؛ لأنهم متفقون على جواز هذا الأمر؛ إلا أنه يسميه تخصيصاً؛ وغيره يسمونه نسخاً؛ والصواب تسميته نسخاً؛ لأنه صريح القرآن: { ما ننسخ من آية أو ننسها }؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف..
.2 ومن فوائد الآية: أن الناسخ خير من المنسوخ؛ لقوله تعالى: { نأت بخير منها }؛ أو مماثل له عملاً . وإن كان خيراً منه مآلاً .؛ لقوله تعالى: ( أو مثلها )
.3 ومنها: أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان؛ بمعنى أنه قد يكون الحكم خيراً للعباد في وقت؛ ويكون غيره خيراً لهم في وقت آخر..
.4 ومنها: عظمة الله عز وجل لقوله تعالى: { ما ننسخ }: فإن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة..
.5 . ومنها: إثبات تمام قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: { ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير }؛ ومن ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء..
.6 ومنها: أن قدرة الله عامة شاملة؛ لقوله تعالى: ( أن الله على كل شيء قدير ).
.7 ومنها: أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية؛ فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها؛ فإذا كان قادراً عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية؛ وهذا هو الحكمة في قوله تعالى: { ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير } بعد ذكر النسخ..
.8 ومنها: أن الشريعة تابعة للمصالح؛ لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة؛ فإن الله لا يبدل حكماً بحكم إلا لمصلحة..
قد يقول قائل: ما الفائدة إذاً من النسخ إذا كانت مثلها والله تعالى حكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة؟
فالجواب: أن الفائدة اختبار المكلف بالامتثال؛ لأنه إذا امتثل الأمر أولاً وآخراً، دل على كمال عبوديته؛ وإذا لم يمتثل دل على أنه يعبد هواه، ولا يعبد مولاه؛ مثال ذلك: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ هذا بالنسبة للمكلف ليس فيه فرق أن يتجه يميناً، أو شمالاً؛ إنما الحكمة من ذلك اختبار المرء بامتثاله أن يتجه حيثما وجه؛ أما المتجَه إليه، وكونه أولى بالاتجاه إليه فلا ريب أن الاتجاه إلى الكعبة أولى من الاتجاه إلى بيت المقدس؛ ولهذا ضل من ضل، وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة: قال الله تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله} [البقرة: 143] ؛ فالإنسان يبتلى بمثل هذا النسخ؛ إن كان مؤمناً عابداً لله قال: سمعت وأطعت؛ وإن كان سوى ذلك عاند، وخالف: يقول: لماذا هذا التغيير! فيتبين بذلك العابد حقاً، ومن ليس بعابد..
.9 ومن فوائد الآية: أن الله تعالى وعد بأنه لا يمكن أن ينسخ شيئاً إلا أبدله بخير منه، أو مثله؛ ووعده صدق..
.10 ومنها: ذكر ما يطمئن به العبد حين يخشى أن يقلق فكره؛ لقوله تعالى: ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها )
القـرآن
)أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (البقرة:107)
التفسير:
.{ 107 } قوله تعالى: { ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض } أي أن الله وحده الذي له ملك السموات، والأرض: ملك الأعيان، والأوصاف، والتدبير؛ فأعيان السموات، والأرض، وأوصافها ملك لله؛ و"التدبير" يعني أنه تعالى يملك التدبير فيها كما يشاء: لا معارض له، ولا ممانع؛ و{ السموات } جمع سماء؛ ويُطلق على العلو، وعلى السقف المحفوظ . وهو المراد هنا .؛ وهي سبع سموات كما جاء في القرآن الكريم، والسنة النبوية؛ و{ الأرض } أي جنس الأرضين، فيشمل السبع كلها..
قوله تعالى: { وما لكم من دون الله } أي من سواه؛ { من ولي }: فعيل بمعنى مفعل؛ أي ما من أحد يتولاكم فيجلب لكم الخير؛ { ولا نصير } أي ولا ناصر يدفع عنكم الشر؛ و{ مِن }: حرف جر زائد إعراباً؛ ولكنه أصلي المعنى؛ إذ إن الغرض منه التنصيص على العموم؛ يعني ما لكم أيّ ولي..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: تقرير عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: { ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض }؛ ولا يرد على هذا إضافة الملك للإنسان، كما في قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] ؛ فإن هذه الإضافة ليست على سبيل الإطلاق؛ لأن ملك الإنسان للأشياء ملك محدود، وناقص، وقاصر؛ محدود من حين استيلائه عليه إلى أن يخرج عن ملكه ببيع، أو هبة، أو موت، أو غير ذلك؛ كذلك هو ناقص: فهو لا يملك التصرف فيه كما يشاء؛ بل تصرفه مقيد بما يباح له شرعاً؛ ولهذا لو أراد أن يحرق ملكه لم يملك ذلك؛ كذلك أيضاً ملك الإنسان قاصر؛ فهو لا يملك إلا ما تحت يده؛ فلا يشمل ملك الآخرين..
.2 ومن فوائد الآية: اختصاص ملك السموات، والأرض بالله؛ وهذا مأخوذ من تقديم الخبر، حيث إن تقديم الخبر يدل على الحصر؛ لقوله تعالى: { له ملك السموات والأرض }..
.3 ومنها: أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاء، ويثبت؛ فكأن قوله تعالى: { ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض } تعليل لقوله تعالى: { ما ننسخ من آية }؛ فالمالك للسموات والأرض يتصرف فيهما كما شاء..
.4 ومنها: أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءاً؛ لقوله تعالى: { وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
.5 ومنها: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية، والنصر..
فإذا قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى يقول: {هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين} [الأنفال: 62] ، ويقول تعالى: {إلا تنصروه فقد نصره الله} [التوبة: 40] ؛ فأثبت نصراً لغير الله..
فالجواب: أن إثبات النصر لغير الله إثبات للسبب فقط؛ وليس نصراً مستقلاً؛ والنصر المستقل من عند الله؛ أما انتصار بعضنا ببعض فإنه من باب الأخذ بالأسباب؛ وليس على وجه الاستقلال..
.6 ومن فوائد الآية: أن ما يريده الإنسان فهو إما جلب منفعة يحتاج إلى ولي يجلبها له؛ وإما دفع مضرة يحتاج إلى نصير يدفعها عنه..
القـرآن
)أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ) (البقرة:108)
التفسير:
.{ 108 } قوله تعالى: { أم تريدون أن تسألوا }؛ { أم } هنا منقطعة بمعنى "بل" وهمزة الاستفهام؛ أي: بل أتريدون؛ والإضراب هنا ليس للإبطال؛ لأن الأول ليس بباطل؛ بل هو باق؛ فالإضراب هنا إضراب انتقال؛ و "الإرادة" هنا بمعنى المشيئة؛ وإن شئت فقل: بمعنى المحبة؛ والخطاب هنا قيل: إنه لليهود حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات يأتي بها؛ وقيل: إنه للمشركين؛ لقوله تعالى: {وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً} [الإسراء: 90] ؛ وقيل: إنه للمسلمين؛ والآية صالحة للأقوال كلها؛ لأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول للجميع؛ لكن تخصيصها باليهود يبعده قوله تعالى: { كما سئل موسى من قبل }؛ فمعنى الآية: أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كان بنو إسرائيل تورد الأسئلة على رسولها؛ ولا شك أن الاستفهام هنا يراد به الإنكار على من يكثرون السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم..
قوله تعالى: { رسولكم }: أضافه سبحانه وتعالى إليهم، مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه: {يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم} [المائدة: 15] ؛ والجمع بين ذلك: أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال: فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله؛ ورسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا؛ والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع..
قوله تعالى: { كما سئل موسى من قبل } أي كما سأل بنو إسرائيل موسى من قبل، كقولهم: {لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة} [البقرة: 55] ، وقولهم: {اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة} [الأعراف: 138] ، وغير ذلك؛ فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة، والتعنت، والإعجاز؛ أما هذه الأمة فإنها قد أدَّبها الله عز وجل فأحسن تأديبها: لا يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة..
قوله تعالى: { ومن يتبدل الكفر بالإيمان } أي يأخذ الكفر بديلاً عن الإيمان؛ { فقد ضل } أي تاه { سواء السبيل } أي وسط الطريق؛ يعني يخرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق، وإلى شعبها؛ وطريق الله واحد؛ وعليك أن تمشي في سواء الصراط . أي وسطه . حتى لا تعرض نفسك للضلال..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: إنكار كثرة الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الاستفهام: { أم تريدون } يقصد به الإنكار؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من ذلك: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم"(163) ؛ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرَّم فحُرِّم من أجل مسألته"(164) ؛ فهذا نهي، وإنكار على الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل؛ والمطلوب من المسلم في زمن الوحي أن يسكت حتى ينزل ما أراد الله عز وجل من أمر أو نهي..
.2 ومن فوائد الآية: تأكيد ذم هذا النوع من الأسئلة؛ لقوله تعالى: { رسولكم }؛ فكأنه أراد أنه لما كان رسولكم، فالذي ينبغي منكم عدم إعناته بالأسئلة..
.3 ومنها: أن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم من مصالحنا، ومنافعنا؛ لقوله تعالى: ( رسولكم )..
.4 ومنها: أن كثرة الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها مشابهة لليهود؛ لقوله تعالى: ( كما سئل موسى من قبل).
.5 ومنها: أنه لا ينبغي إلقاء السؤال إلا لمصلحة: إما رجل وقعت له مسألة يسأل عن حكمها؛ أو طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها؛ أما الأسئلة لمجرد استظهار ما عند الإنسان فقط؛ أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وما أشبه ذلك؛ أو لأجل إعنات المسؤول، وإحراجه؛ فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا تنبغي..
.6 ومن فوائد الآية: ذم بني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية على سبيل الذم..
.7 ومنها: أن اليهود كانوا سألوا موسى عن أشياء فكانت العاقبة فيها وخيمة: فقد سألوا عن أشياء بينت لهم؛ لكنهم لم يعملوا بها؛ فكانت نتيجة السؤال الخيبة..
.8 ومنها: إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: { كما سئل موسى من قبل } يعني: وهو رسول..
.9 ومنها: ذم من استبدل الكفر بالإيمان؛ لقوله تعالى: { ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ؛ وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه، ومن ارتد بعد إيمانه؛ فإنه في الحقيقة تبديل؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة؛ فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان..
.10 ومنها: أن من اختار الكفر على الإيمان فهو ضال..
.11ومنها: عكس هذه المسألة: أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هُدي إلى سواء السبيل..
.12 ومنها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة في عمله، وأنه مجبر عليه؛ لقوله تعالى: { ومن يتبدل الكفر بالإيمان }..
.13 ومنها: أنه يجب على السائل أن يعمل بما أجيب به؛ لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان من بعد ما تبين له أنكر؛ فالواجب على المرء إذا سأل من يثق به أن يعمل بقوله؛ ولهذا قال العلماء: ومن سأل مفتياً ملتزماً بقوله حرم عليه أن يسأل غيره؛ لأنه حين سأله كان يعتقد أن الذي يقوله هو الشرع؛ فإذا كان يعتقد هذا فلا يسأل غيره؛ نعم، إذا سأل إنساناً يثق به بناءً على أن فتواه هو الشرع، وأفتاه، ولكنه سمع في مجلس عالم آخر حكماً نقيض الذي أُفتي به مدعَّماً بالأدلة، فحينئذ له أن ينتقل؛ بل يجب عليه؛ أو سأل عالماً مقتنعاً بقوله للضرورة . لأنه ليس عنده في البلد أعلم منه . على نية أنه إذا وجد أعلم منه سأله؛ فهذا أيضاً يجوز أن يسأل غيره إذا وجد أعلم منه..
القـرآن
)وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة:109)
التفسير:
.{ 109 } قوله تعالى: { ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً }؛ { ود } بمعنى أحب؛ بل إن "الود" خالص المحبة؛ والمعنى: أن كثيراً من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم أن يردوكم كفاراً؛ أي يرجعوكم كفاراً؛ وعلى هذا فـ{ يردونكم } تنصب مفعولين؛ الأول: الكاف في { يردونكم }؛ والثاني: { كفاراً }؛ و{ أهل الكتاب } هم اليهود، والنصارى؛ والمراد بـ{ الكتاب } التوراة، والإنجيل؛ و{ لو } هنا مصدرية؛ وضابطها أن تقع بعد "ود" ونحوها؛ و{ من بعد إيمانكم } أي من بعد أن ثبت الإيمان في قلوبكم..
قوله تعالى: { حسداً } مفعول لأجله عامله: { ود }؛ أي ودوا من أجل الحسد؛ يعني هذا الود لا لشيء سوى الحسد؛ لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة؛ وهؤلاء الكفار أعداء؛ والعدو يحسد عدوه على ما حصل له من نعمة الله؛ و "الحسد" تمني زوال نعمة الله على الغير سواء تمنى أن تكون له، أو لغيره، أو لا لأحد؛ فمن تمنى ذلك فهو الحاسد؛ وقيل: "الحسد" كراهة نعمة الله على الغير..
قوله تعالى: { من عند أنفسهم } أي هذه المودة التي يودونها ليست لله، ولا من الله؛ ولكن من عند أنفسهم..
قوله تعالى: { من بعد ما تبين } أي من بعد ما ظهر { لهم } أي لهؤلاء الكثيرين؛ { الحق } أي ما أنتم عليه من الحق؛ و "الحق" هو الشيء الثابت؛ فإن وصف به الحكم فالمراد به العدل؛ وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق؛ فـ{ الحق } الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام؛ ودين الإسلام على هذا؛ وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا؛ فإن أخباره صدق، وأحكامه عدل..
قوله تعالى: { فاعفوا واصفحوا }: الخطاب للمؤمنين عامة؛ ويدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ و "العفو" بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب؛ كأنه من عفا الأثر: إذا زال لتقادمه؛ و{ اصفحوا }: قيل: إنه من باب عطف المترادفين، كقول الشاعر:
(فألفى قولها كذباً وميناً) و"الكذب" و"المين" معناهما واحد؛ ولكن الصواب أن بين "العفو" ، و "الصفح" فرقاً؛ فـ "العفو" ترك المؤاخذة على الذنب؛ و "الصفح" الإعراض عنه؛ مأخوذ من صفحة العنق؛ وهو أن الإنسان يلتفت، ولا كأن شيئاً صار . يوليه صفحة عنقه .؛ فـ "الصفح" معناه الإعراض عن هذا بالكلية وكأنه لم يكن؛ فعلى هذا يكون بينهما فرق؛ فـ "الصفح" أكمل إذا اقترن بـ "العفْو" ..
قوله تعالى: { حتى يأتي الله بأمره } أي بأمر سوى ذلك؛ وهو الأمر بالقتال..
قوله تعالى: { إن الله على كل شيء قدير } أي لا يعتريه عجز في كل شيء فعله..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: بيان شدة عداوة اليهود، والنصارى للأمة الإسلامية؛ وجه ذلك أن كثيراً منهم يودون أن يردوا المسلمين كفاراً حسداً من عند أنفسهم..
.2 ومنها: أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة؛ لقوله تعالى: { لو يردونكم }؛ ولهذا الذي يكفر بعد الإسلام لا يسمى باسم الدين الذي ارتد إليه؛ فلو ارتد عن الإسلام إلى اليهودية، أو النصرانية لم يعط حكم اليهود، والنصارى..
.3 ومنها: أن الحسد من صفات اليهود، والنصارى..
.4 ومنها: تحريم الحسد؛ لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"(165) ؛ واعلم أن الواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن يسأل الله من فضله، ولا يكره ما أنعم الله به على الآخرين، أو يتمنى زواله؛ لقوله تعالى: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله} [النساء: 32] ؛ والحاسد لا يزداد بحسده إلا ناراً تتلظى في جوفه؛ وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة؛ فهو مع كونه كارهاً لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه؛ لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود؛ ثم إن الحاسد أو الحسود . مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلاً فيها؛ لأنه لابد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه، فيحتقر النعمة؛ حتى لو فرضنا أنه تميز بأموال كثيرة، وجاء إنسان تاجر، وكسب مكسباً كبيراً في سلعة معينة تجد هذا الحاسد يحسده على هذا المكسب بينما عنده ملايين كثيرة؛ وكذلك أيضاً بالنسبة للعلم: بعض الحاسدين إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم تجده . وإن كان أعلم منه . يحسده على ما برز به؛ وهذا يستلزم أن يحتقر نعمة الله عليه؛ فالحسد أمره عظيم، وعاقبته وخيمة؛ والناس في خير، والحسود في شر: يتتبع نعم الله على العباد؛ وكلما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه؛ ولو لم يكن من خُلُق الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافياً في النفور منه..
.5 ومن فوائد الآية: علم اليهود، والنصارى أن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه؛ لقوله تعالى: { حسداً }؛ لأن الإنسان لا يحسد إلا على شيء يكون خيراً، ومنقبة؛ ويدل لذلك قوله تعالى: {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم} [البقرة: 105] ..
.6 ومنها: وجوب الحذر من اليهود، والنصارى؛ ما دام كثير منهم يودون لنا هذا فإنه يجب علينا أن نحذر منهم..
.7 ومنها: بيان خبث طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر؛ لقوله تعالى: { من عند أنفسهم }؛ ليس من كتاب، ولا من إساءة المسلمين إليهم؛ ولكنه من عند أنفسهم: أنفس خبيثة تود الكفر للمسلمين حسداً..
.8 ومنها: أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين لهم الحق؛ فلو كانوا جاهلين بأن المسلمين على حق، وقالوا: "لا نريد أن نكون على دين مشكوك فيه" لكان لهم بعض العذر؛ ولكنهم قد تبين لهم الحق، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن دينه حق، وأن المؤمنين على حق؛ ومع ذلك فهم يودون هذه المودة، ويسعون بكل سبيل أن يصلوا إلى غايتهم؛ فمن أحب شيئاً سعى في تحصيله؛ فكثير من هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية، أو أخلاقية، أو غيرهما ليردوا المسلمين بعد الإيمان كفاراً..
.9 ومن فوائد الآية: مراعاة الأحوال، وتطور الشريعة، حيث قال تعالى: { فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره }..
.10 ومنها: أن الذم إنما يقع على من تبين له الحق؛ وأما الجاهل فهو معذور بجهله إذا لم يقصر في طلب العلم..
11 . ومنها: جواز مهادنة الكفار إذا لم يكن للمسلمين قوة..
.12 ومنها: إثبات الحكمة لله عز وجل، حيث أمر بالعفو، والصفح إلى أن يأتي الله بأمره؛ لأن الأمر بالقتال قبل وجود أسبابه، وتوفر شروطه من القوة المادية والبشرية، ينافي الحكمة..
.13 ومنها: الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل؛ والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد فعلاً يليق بجلاله وعظمته، وما تقتضيه حكمته؛ لقوله تعالى: { حتى يأتي الله بأمره }..
.14 ومنها: ثبوت القدرة لله عز وجل، وأنها شاملة لكل شيء؛ لقوله تعالى: ( إن الله على كل شيء قدير )
.15 ومنها: الرد على المعتزلة القدرية؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ وإذا كان مستقلاً بعمله لزم من ذلك أن الله لا يقدر على تغييره؛ لأنه إن قدر على تغييره صار العبد غير مستقل..
.16 ومنها: بشارة المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سيغير حالهم المقتضية للعفو والصفح، إلى قوة يستطيعون بها جهاد العدو..
.17 ومنها: اتباع الحكمة في الدعوة إلى الله بالصبر، والمصابرة حتى يتحقق النصر، وأنْ تعامَل كل حال بما يناسبها..
القـرآن
)وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة:110)
التفسير:
.{ 110 } قوله تعالى: { وأقيموا الصلاة } يعني أدوا الصلاة على وجه الكمال؛ لأن إقامة الشيء جعله قيماً معتدلاً مستقيماً؛ فمعنى { أقيموا الصلاة } أي ائتوا بها كاملة بشروطها، وواجباتها، وأركانها، ومكملاتها.
قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} أي أعطوها؛ وهنا حذف المفعول الثاني؛ والتقدير: وآتوا الزكاة مستحقيها؛ و{ الزكاة } المفعول الأول؛ ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء...} إلخ [التوبة: 60] ..
و"الزكاة" في اللغة النماء، والزيادة؛ ومنه قولهم: "زكا الزرع" إذا نما، وزاد؛ وفي الشرع هي دفع مال مخصوص لطائفة مخصوصة تعبداً لله عز وجل؛ وسميت زكاة؛ لأنها تزكي الإنسان، كما قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] ؛ فهي تزكي الإنسان في أخلاقه، وعقيدته، وتطهره من الرذائل؛ لأنها تخرجه من حظيرة البخلاء إلى حظيرة الأجواد، والكرماء؛ وتكفِّر سيئاته..
قوله تعالى: { وما تقدموا لأنفسكم }؛ { ما } شرطية؛ لأنها جزمت فعل الشرط، وجوابه..
قوله تعالى: { من خير } يشمل ما يقدمه من المال، والأعمال؛ وهو بيان للمبهم في اسم الشرط..
ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى: {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء} [البقرة: 261].
قوله تعالى: { إن الله بما تعملون بصير }؛ هذه الجملة مؤكدة بـ{ إن } مع أن الخطاب ابتدائي؛ إذ إنه لم يوجه إلى متردد، ولا منكر؛ والخطاب إذا لم يوجه لمنكر، ولا متردد فإنه يسمى ابتدائياً؛ والابتدائي لا يؤكد؛ لأنه لا حاجة لذلك؛ ولكنه قد يؤكد لا باعتبار حال المخاطب؛ لكن باعتبار أهمية مدلوله؛ فهنا له أهمية عظيمة: أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه بكل ما نعمل بصير؛ و{ ما } اسم موصول يفيد العموم؛ أي بما نعمل قلبياً، وبدنياً؛ قولياً، وفعلياً؛ لأن القلوب لها أعمال كالمحبة، والخوف، والرجاء، والرغبة، وما أشبه ذلك؛ و{ بما تعملون } متعلقة بـ{ بصير }؛ وقدمت عليها لغرضين؛ الأول: مراعاة الفواصل؛ لأن التي قبلها فاصلة بالراء: { قدير }، وبعدها: { بصير }؛ والثاني: من أجل الحصر؛ والحصر هنا وإن كان يقلل من العموم لكنه يفيد الترهيب والترغيب؛ لأنه إذا قيل: أيهما أعظم في التهديد أو الترغيب، أن نقول: إن الله بصير بكل شيء مما نعمل، ومما لا نعمل؛ أو أنه بصير بما نعمل فقط؟
فالجواب: أن الأول أعم؛ والثاني أبلغ في التهديد، أو الترغيب؛ وهو المناسب هنا؛ كأنه يقول: لو لم يكن الله بصيراً إلا بأعمالكم فإنه كاف في ردعكم، وامتثالكم؛ و{ بصير } ليس من البصر الذي هو الرؤية؛ لكن من البصر الذي بمعنى العلم؛ لأنه أشمل حيث يعم العمل القلبي، والبدني؛ والعمل القلبي لا يدرك بالرؤية.
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: وجوب إقامة الصلاة؛ والصلاة تشمل الفريضة والنافلة؛ ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل؛ لأنه جاء في الحديث(166) أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة؛ ما من إنسان إلا وفي فريضته نقص؛ لكن هذه النوافل تكملها، وترقعها..
.2 ومنها: وجوب إيتاء الزكاة . يعني لمستحقيها ...
.3 ومنها: أن الصلاة أوكد من الزكاة؛ ولهذا يقدمها الله عليها في الذكر..
.4 ومنها: أن إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة من أسباب النصر؛ لأن الله ذكرها بعد قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} [البقرة: 109] ؛ وقد جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى: {ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز * الذين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور} [الحج: 40، 41] ..
.5 ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بالأهم فالأهم مع الدعوة إلى الله عز وجل..
.6 ومنها: أن كل خير يقدمه العبد لربه عز وجل فإنه سيجد ثوابه عنده..
.7 ومنها: أن الثواب عام لجميع الأعمال صغيرها، وكبيرها؛ لقوله تعالى: { من خير }؛ فإنها نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد العموم؛ فأيّ خير قدمته قليلاً كان، أو كثيراً ستجد ثوابه؛ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"(167) ..
.8 ومنها: الترغيب في فعل الخير، حيث إن الإنسان يجد ثوابه عند ربه مدخراً له . وهو أحوج ما يكون إليه ...
.9 ومنها: أن الإنسان إذا قدم خيراً فإنما يقدمه لنفسه؛ لقوله تعالى: { وما تقدموا لأنفسكم من خير }؛ ولهذا ليس له من ماله إلا ما أنفق لله؛ وما أخره فلوارثه..
.10 ومنها: عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل..
.11 ومنها: التحذير من المخالفة؛ لقوله تعالى: ( إن الله بما تعملون بصير )
القـرآن
)وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (البقرة:111)
التفسير:
.{ 111 } قوله تعالى: { وقالوا } أي اليهود، والنصارى؛ { لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً }: هذا قول اليهود؛ { أو نصارى }: هذا قول النصارى..
قوله تعالى: { تلك أمانيهم } أي تلك المقالة؛ و{ أمانيهم } جمع أمنية؛ وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه..
قوله تعالى: { قل } أي يا محمد؛ { هاتوا }: فعل أمر؛ لأن ما دل على الطلب، ولحقته العلامة فهو فعل أمر؛ يقال: "هاتي" للمرأة؛ "هاتيا" للاثنين؛ والأمر هنا للتحدي، والتعجيز؛ { برهانكم } أي دليلكم؛ مِن "برهن على الشيء": إذا بينه؛ أو من "بَرَه الشيء": إذا وضح بالعلامة؛ فعلى الأول تكون النون أصلية؛ وعلى الثاني تكون النون زائدة؛ وعلى القولين جميعاً فـ "البرهان" هو الذي يتبين به حجة الخصم؛ يعني ما نقبل كلامكم إلا إذا أقمتم عليه الدليل؛ فإذا أقمتم عليه الدليل فهو على العين، والرأس..
قوله تعالى: { إن كنتم صادقين } يعني أن هذا أمر لا يمكن وقوعه؛ فهو تحدٍّ، كقوله تعالى: {فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم} [البقرة: 94، 95] ؛ فإذا كانوا صادقين في زعمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، أو نصارى فليأتوا بالبرهان؛ ولن يأتوا به؛ إذاً يكونون كاذبين.
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: بيان ما كان عليه اليهود، والنصارى من الإعجاب بما هم عليه من الدين..
.2 ومنها: تعصب اليهود، والنصارى؛ وتحجيرهم لفضل الله..
.3 ومنها: أن ما ادعوه كذب؛ لقوله تعالى: { تلك أمانيهم }؛ فعلى قول هؤلاء اليهود يكون النصارى، والمسلمون لن يدخلوا الجنة؛ وقد سبق أن قالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ثم تخلفوننا فيها؛ وعلى قول النصارى لا يدخل اليهود، ولا المسلمون الجنة؛ أما اليهود فصحيح: فإنهم كفروا بعيسى، وبمحمد؛ ومن كفر بهما فإنه لن يدخل الجنة؛ وأما بالنسبة للمسلمين فغير صحيح؛ بل المسلمون هم أهل الجنة؛ وأما اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أهل النار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"(168) ؛ فالحاصل أن هذا القول . وهو قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى . كذب من الطرفين؛ ولهذا قال تعالى: { تلك أمانيهم }؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني(169)" ..
.4 ومن فوائد الآية: أن من اغتر بالأماني، وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شَبه من اليهود، والنصارى..
.5 ومنها: عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده، حيث قال تعالى: { قل هاتوا برهانكم }؛ لأن هذا من باب مراعاة الخصم، وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها؛ وهذا لا شك من أبلغ ما يكون من العدل؛ وإلا فالحكم لله العلي الكبير..
.6 ومنها: أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعَوه بدليل أنهم لم يأتوا به..
.7 ومنها: أنهم كاذبون؛ لقوله تعالى: { إن كنتم صادقين }؛ ولو كان لهم أدنى حيلة بما يبرر قولهم، ويصدِّقه لأتوا بها..
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة:104)
التفسير:
.{ 104 } قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }: تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المنادَى؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص في الإيمان؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: { يا أيها الذين آمنوا } فأرعها سمعك . يعني استمع لها .؛ فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه"(159). وهذه الآية من النهي: { لا تقولوا راعنا} يعني لا تقولوا عند مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم راعنا؛ و{ راعنا } من المراعاة؛ وهي العناية بالشيء، والمحافظة عليه؛ وكان الصحابة إذا أرادوا أن يتكلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: "يا رسول الله، راعنا" ؛ وكان اليهود يقولون: "يا محمد، راعنا"؛ لكن اليهود يريدون بها معنى سيئاً؛ يريدون "راعنا" اسم فاعل من الرعونة؛ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم راعن؛ ومعنى "الرعونة" الحمق، والهوج؛ لكن لما كان اللفظ واحداً وهو محتمل للمعنيين نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوه تأدباً، وابتعاداً عن سوء الظن؛ ولأن من الناس من يتظاهر بالإيمان . مثل المنافقين . فربما يقول: "راعنا" وهو يريد ما أرادت اليهود؛ فلهذا نُهي المسلمون عن ذلك..
قوله تعالى: { وقولوا انظرنا } يعني إذا أردتم من الرسول أن ينتظركم فلا تقولوا: { راعنا }؛ ولكن قولوا: { انظرنا }: فعل طلب؛ و"النظر" هنا بمعنى الانتظار، كما في قوله تعالى: {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام} [البقرة: 210] ، أي ما ينتظر هؤلاء..
قوله تعالى: { واسمعوا } فعل أمر من السمع بمعنى الاستجابة؛ أي اسمعوا سماع استجابة، وقبول، كما قال تعالى: {ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون} [الأنفال: 21] يعني اسمعوا ما تؤمرون به فافعلوه، وما تنهون عنه فاتركوه..
قوله تعالى: { وللكافرين عذاب أليم }؛ المراد بـ "الكافرين" هنا اليهود؛ و{ عذاب } بمعنى عقوبة؛ و{ أليم } بمعنى مؤلم..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: أنه ينبغي استعمال الأدب في الألفاظ؛ يعني أن يُتجنب الألفاظ التي توهم سبًّا، وشتماً؛ لقوله تعالى: { لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا..
.2 ومنها: أن الإيمان مقتضٍ لكل الأخلاق الفاضلة؛ لأن مراعاة الأدب في اللفظ من الأخلاق الفاضلة..
.3 ومنها: أن مراعاة الأخلاق الفاضلة من الإيمان..
.4 ومنها: أنه ينبغي لمن نهى عن شيء أن يدل الناس على بدله المباح؛ فلا ينهاهم، ويجعلهم في حيرة..
.5 ومنها: وجوب الانقياد لأمر الله ورسوله؛ لقوله تعالى: ( واسمعوا )
.6 ومنها: التحذير من مخالفة أمر الله، وأنها من أعمال الكافرين؛ لقوله تعالى: (وللكافرين عذاب أليم )
القـرآن
)مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (البقرة:105)
التفسير:
.{ 105 } قوله تعالى: { ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين }؛ { ما } نافية؛ و{ يود } بمعنى يحب؛ و "الود" خالص المحبة؛ و{ مِن } هنا لبيان الجنس؛ وليست للتبعيض؛ وعليه يصير المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار؛ { ولا المشركين } معطوفة على قوله تعالى: { من أهل الكتاب } يعني: ما يود الذين كفروا من هؤلاء، ولا هؤلاء؛ ولهذا قال تعالى: { ولا المشركين }؛ لأنها لو كانت معطوفة على { الذين كفروا } لكانت بالرفع؛ فعلى هذا تكون { من } لبيان الجنس؛ أي الذين كفروا من هذا الصنف . الذين هم أهل الكتاب؛ وكذلك من المشركين..
قوله تعالى: { أن ينزل عليكم من خير من ربكم }: { أن ينزل } مفعول { يود } يعني: ما يودون تنزيل خير؛ وقوله تعالى: { من خير }: { مِن } زائدة إعراباً؛ و "الخير" هنا يشمل خير الدنيا، والآخرة، القليل والكثير؛ لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من اليهود، والنصارى، ومن المشركين أن يمنعوا القطر عن المسلمين لفعلوا؛ لأنهم ما يودون أن ينزل علينا أيّ خير؛ ولو تمكنوا أن يمنعوا العلم النافع عنا لفعلوا؛ وهذا ليس خاصاً بأهل الكتاب والمشركين في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم؛ بل هو عام؛ ولهذا جاء بصيغة المضارع: { ما يود }؛ وهو دال على الاستمرار..
وقوله تعالى: { ينزَّل } بتشديد الزاي؛ وفي قراءة بدون تشديد؛ والفرق بينهما أن "التنزيل" : هو إنزاله شيئاً فشيئاً؛ وأما "الإنزال" : فهو إنزاله جملة واحدة؛ هذا هو الأصل؛ فهم لا يودون هذا، ولا هذا: لا أن ينزل علينا الخير جملة واحدة؛ ولا أن ينزل شيئاً فشيئاً..
قوله تعالى: { والله يختص برحمته من يشاء }؛ "يختص" تستعمل لازمة، ومتعدية؛ فإن كانت لازمة فإن { مَن } فاعل { يختص }؛ والمعنى على هذا: ينفرد برحمته من يشاء؛ كما تقول: اختصصت بهذا الشيء: أي انفردت به؛ وإن كانت متعدية فهي بمعنى: يخص برحمته من يشاء؛ وعلى هذا فتكون { مَن } مفعولاً به لـ{ يختص }؛ وعلى كلا الوجهين المعنى واحد: أي أن الله عز وجل يخص برحمته من يشاء؛ فيختص بها..
وقوله تعالى: { برحمته } يشمل رحمة الدين، والدنيا؛ ومن ذلك رحمة الله بإنزال هذا الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو من رحمة الله عليه، وعلينا، كما قال تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} (الأنبياء: 107).
وقوله تعالى: { من يشاء } هذا مقرون بالحكمة؛ يعني اختصاصه بالرحمة لمن يشاء مبني على حكمته سبحانه وتعالى؛ فمن اقتضت حكمته ألا يختصه بالرحمة لم يرحمه..
قوله تعالى: { والله ذو الفضل } أي ذو العطاء الزائد عما تتعلق به الضرورة؛ و{ العظيم } أي الواسع الكثير الكبير؛ فالعِظم هنا يعود إلى الكمية، وإلى الكيفية..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: بيان عداوة غير المسلمين للمسلمين؛ لأنه تعالى ذكر صنفين ينتظمان جميع الأصناف: أهل الكتاب . وهم اليهود، والنصارى .؛ والمشركين . وهم كل أصحاب الأوثان .؛ فكل هؤلاء أعداء للمسلمين؛ لأنهم لا يودون الخير للمسلمين..
.2 ومنها: أنه يجب علينا أن نحذر من كل تصرف يصدر عن اليهود، والنصارى، والمشركين، ونتخذهم أعداءً، وأن نعلم أنهم بجميع تصرفاتهم يحاولون أن يمنعوا الخير عن المسلمين..
.3 ومنها: أن هؤلاء الكفار يودون أن يمنعوا عن المسلمين التقدم..
.4 ومنها: أنه يحرم على المسلمين أن يُوَلُّوا هؤلاء الكفار أيّ قيادة؛ لأنهم ما داموا لا يودون لنا الخير فلن يقودونا لأيّ خير مهما كان الأمر؛ ولهذا يحرم أن يجعل لهم سلطة على المسلمين لا في تخطيط، ولا في نظام، ولا في أي شيء؛ بل يجب أن يكونوا تحت إمرة المسلمين، وتحت تدبيرهم ما أمكن؛ وإذا استعنا بهم فإنما نستعين بهم لإدراك مصالحنا وهم تحت سلطتنا؛ لأنهم لو استطاعوا أن يمنعوا القطر وينبوع الأرض عن المسلمين لفعلوا؛ إذاً فيجب علينا الحذر من مخططاتهم، وأن نكون دائماً على سوء ظن بهم؛ لأن إحسان الظن بهم في غير محله؛ وإنما يحمل عليه الذل، وضعف الشخصية، والخور، والجبن؛ ولهذا قال تعالى: { ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم }؛ وهي شاملة لخير الدنيا، والآخرة؛ فاليهود حسدوا المسلمين لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونزل عليهم هذا الكتاب..
.5 ومن فوائد الآية: أن خير الله لا يجلبه ودّ وادّ، ولا يرده كراهة كاره؛ لقوله تعالى: { والله يختص برحمته من يشاء }؛ فلا يمكن لهؤلاء اليهود، والنصارى، والمشركين أن يمنعوا فضل الله علينا؛ وعلى هذا جاء الحديث الصحيح: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك(160)" ..
.6 . ومنها: أن الإنسان الذي لا يود الخير للمسلمين فيه شبه باليهود، والنصارى؛ لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم..
.7 ومنها: إثبات المشيئة لله؛ لقوله تعالى: { من يشاء }؛ ومشيئته تعالى عامة في كل شيء سواء كان من أفعاله، أو من أفعال عباده؛ لقوله تعالى: {ولو شاء الله ما فعلوه} [الأنعام: 137] ، وقوله تعالى: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين} [التكوير: 29] ؛ وأما ما يتعلق بأفعاله تعالى فالأمثلة عليه كثيرة، كقوله تعالى: {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها} [السجدة: 13] ، وقوله تعالى: {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد} [فاطر: 16] ، وقوله تعالى: { والله يفعل ما يشاء }، وغير ذلك من الآية..
.8 ومن فوائد الآية: إثبات الرحمة لله؛ لقوله تعالى: ( برحمته )
.9 ومنها: إثبات الإرادة لله؛ لقوله تعالى: { يختص }؛ لأن التخصيص يدل على الإرادة..
.10 ومنها: إثبات الفضل لله؛ لقوله تعالى: ( ذو الفضل )
.11 ومنها: إثبات أن فضله ليس كفضل غيره؛ ففضل غيره محدود؛ وأما فضل الله ففضل عظيم لا حدود له؛ فإن الله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم؛ ومن فضله تبارك وتعالى أنه خص هذه الأمة بخصائص عظيمة كثيرة ما جعلها لأحد سواها؛ منها ما جاء في حديث جابر في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ؛ وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي؛ وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة"(161) ..
تــنــبــيــه:.
لا يعارض هذه الآية قوله تعالى: {لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون} [المائدة: 82] ؛ لأن هذه الآية في صنف معين من النصارى: وهم الذين منهم القسيسون، والرهبان الذين من صفاتهم أنهم لا يستكبرون؛ فإذا وجد هذا الصنف في عهد الرسول، أو بعده انطبقت عليه الآية؛ لكن اختلفت حال النصارى منذ زمن بعيد؛ نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزتهم وكرامتهم، حتى يعرفوا حقيقة عداوة النصارى، وغيرهم من أهل الكفر، فيعدوا لهم العدة..
القـرآن
)مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة:106)
التفسير:
.{ 106 } قوله تعالى: { ما ننسخ من آية أو ننسها } فيها ثلاث قراءات؛ الأولى: بفتح النون الأولى في { نَنسخ }؛ وضمها في { نُنسها } بدون همز؛ والثانية: بفتح النون الأولى في { نَنسخ }؛ وفتحها في { نَنسأها } مع الهمز؛ والثالثة بضم النون الأولى في { نُنسخ }؛ وضمها في { نُنسها } بدون همز..
قوله تعالى: { ما ننسخ من آية... }؛ { ما }: شرطية؛ وهي اسم شرط جازم يجزم فعلين؛ الأول: فعل الشرط: { ننسخ }؛ والثاني: جوابه: { نأت }؛ وأما قوله تعالى: { أو ننسها } فهي معطوفة على ( ننسخ )
وقوله تعالى: { ننسخ من آية أو ننسها } بضمير الجمع للتعظيم؛ وليس للتعدد؛ لأن الله واحد؛ و"النسخ" معناه في اللغة: الإزالة؛ أو ما يشبه النقل؛ فالأول كقولهم: "نسخت الشمس الظل" يعني أزالته؛ والثاني كقولهم: "نسخت الكتاب"؛ إذ ناسخ الكتاب لم يزله، ولم ينقله؛ وإنما نقش حروفه، وكلماته؛ لأنه لو كان "نسخ الكتاب" يعني نقله كان إذا نسخته انمحت حروفه من الأول؛ وليس الأمر كذلك؛ أما في الشرع: فإنه رفع حكم دليل شرعي، أو لفظه، بدليل شرعي؛ و{ مِن } لبيان الجنس؛ لأن { ما } اسم شرط جازم مبهم؛ والمراد بـ "الآية" الآية الشرعية؛ لأنها محل النسخ الذي به الأمر والنهي دون الآية الكونية..
وقوله: { ننسها } من النسيان؛ وهو ذهول القلب عن معلوم؛ وأما { ننسأها } فهو من "النسأ"؛ وهو التأخير؛ ومعناه: تأخير الحكم، أو تأخير الإنزال؛ أي أن الله يؤخر إنزالها، فتكون الآية لم تنزل بعد؛ ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلها بغيرها؛ وأما على قراءة { ننسها } فهو من النسيان؛ بمعنى نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم ينساها، كما في قوله تعالى: {سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله} [الأعلى: 6 . 7] ؛ والمراد به هنا رفع الآية؛ وليس مجرد النسيان؛ لأن مجرد النسيان لا يقتضي النسخ؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآية؛ وهي باقية كما في الحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة فترك شيئاً لم يقرأه فقال له رجل: تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلَّا أذكرتنيها(162)" ..
قوله تعالى: { نأت بخير منها } هو جواب الشرط؛ والخيرية هنا بالنسبة للمكلف؛ ووجه الخيرية . كما يقول العلماء . أن النسخ إن كان إلى أشد فالخيرية بكثرة الثواب؛ وإن كان إلى أخف فالخيرية بالتسهيل على العباد مع تمام الأجر؛ وإن كان بالمماثل فالخيرية باستسلام العبد لأحكام الله عز وجل، وتمام انقياده لها، كما قال تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه} [البقرة: 143] ..
قوله تعالى: { أو مثلها } أي نأتي بمثلها..
قوله تعالى: { ألم تعلم } الهمزة هنا للاستفهام؛ والمراد به التقرير؛ وكلما جاءت على هذه الصيغة فالاستفهام فيها للتقرير، مثل: {ألم نشرح لك صدرك} [الشرح: 1] ؛ فقوله تعالى: { ألم تعلم } يقرر الله المخاطَب . سواء قلنا: إنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ أو كل من يتأتى خطابه . بالاستفهام بأنه يعلم { أن الله على كل شيء قدير }؛ يعني أنك قد علمت قدرة الله على كل شيء؛ ومنها القدرة على النسخ..
وقوله تعالى: { قدير }: لما أريد بها الوصف جاءت على صيغة "فعيل"؛ لكن إذا أريد بها الفعل تكون بصيغة "الفاعل"، كما في قوله تعالى: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم} [الأنعام: 65] ؛ و "القدرة" صفة تقوم بالقادر بحيث يفعل الفعل بلا عجز؛ و"القوة" صفة تقوم بالقوي بحيث يفعل الفعل بلا ضعف؛ إذاً المقابل للقدرة: العجز؛ لقوله تعالى: {وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديراً} [فاطر: 44] ؛ والمقابل للقوة: الضعف، قال تعالى: {الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة} [الروم: 54] ؛ والفرق الثاني بينهما: أن "القوة" يوصف بها من له إرادة، وما ليس له إرادة؛ فيقال: رجل قوي؛ وحديد قوي؛ وأما "القدرة" فلا يوصف بها إلا ذو إرادة؛ فلا يقال: حديد قادر..
تــنــبــيــه:.
من هذا الموضع من السورة إلى ذكر تحويل القبلة في أول الجزء الثاني تجد أن كل الآيات توطئة لنسخ استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ ولهذا تجد الآيات بعدها كلها في التحدث مع أهل الكتاب الذين أنكروا غاية الإنكار تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: ثبوت النسخ، وأنه جائز عقلاً، وواقع شرعاً؛ وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني؛ فإنه زعم أن النسخ مستحيل؛ وأجاب عما ثبت نسخه بأن هذا من باب التخصيص؛ وليس من باب النسخ؛ وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه؛ بل أمدها إلى يوم القيامة؛ فإذا نُسِخت فمعناه أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ . أي أخرجناه من الحكم .؛ فمثلاً: وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجباً إلى يوم القيامة شاملاً لجميع الأزمان؛ فلما نُسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصاً؛ وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وعامة الأمة خلافاً لفظياً؛ لأنهم متفقون على جواز هذا الأمر؛ إلا أنه يسميه تخصيصاً؛ وغيره يسمونه نسخاً؛ والصواب تسميته نسخاً؛ لأنه صريح القرآن: { ما ننسخ من آية أو ننسها }؛ ولأنه هو الذي جاء عن السلف..
.2 ومن فوائد الآية: أن الناسخ خير من المنسوخ؛ لقوله تعالى: { نأت بخير منها }؛ أو مماثل له عملاً . وإن كان خيراً منه مآلاً .؛ لقوله تعالى: ( أو مثلها )
.3 ومنها: أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان؛ بمعنى أنه قد يكون الحكم خيراً للعباد في وقت؛ ويكون غيره خيراً لهم في وقت آخر..
.4 ومنها: عظمة الله عز وجل لقوله تعالى: { ما ننسخ }: فإن الضمير هنا للتعظيم؛ وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة..
.5 . ومنها: إثبات تمام قدرة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: { ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير }؛ ومن ذلك أنه قادر على أن ينسخ ما يشاء..
.6 ومنها: أن قدرة الله عامة شاملة؛ لقوله تعالى: ( أن الله على كل شيء قدير ).
.7 ومنها: أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية؛ فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها؛ فإذا كان قادراً عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية؛ وهذا هو الحكمة في قوله تعالى: { ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير } بعد ذكر النسخ..
.8 ومنها: أن الشريعة تابعة للمصالح؛ لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة؛ فإن الله لا يبدل حكماً بحكم إلا لمصلحة..
قد يقول قائل: ما الفائدة إذاً من النسخ إذا كانت مثلها والله تعالى حكيم لا يفعل شيئاً إلا لحكمة؟
فالجواب: أن الفائدة اختبار المكلف بالامتثال؛ لأنه إذا امتثل الأمر أولاً وآخراً، دل على كمال عبوديته؛ وإذا لم يمتثل دل على أنه يعبد هواه، ولا يعبد مولاه؛ مثال ذلك: تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؛ هذا بالنسبة للمكلف ليس فيه فرق أن يتجه يميناً، أو شمالاً؛ إنما الحكمة من ذلك اختبار المرء بامتثاله أن يتجه حيثما وجه؛ أما المتجَه إليه، وكونه أولى بالاتجاه إليه فلا ريب أن الاتجاه إلى الكعبة أولى من الاتجاه إلى بيت المقدس؛ ولهذا ضل من ضل، وارتد من ارتد بسبب تحويل القبلة: قال الله تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله} [البقرة: 143] ؛ فالإنسان يبتلى بمثل هذا النسخ؛ إن كان مؤمناً عابداً لله قال: سمعت وأطعت؛ وإن كان سوى ذلك عاند، وخالف: يقول: لماذا هذا التغيير! فيتبين بذلك العابد حقاً، ومن ليس بعابد..
.9 ومن فوائد الآية: أن الله تعالى وعد بأنه لا يمكن أن ينسخ شيئاً إلا أبدله بخير منه، أو مثله؛ ووعده صدق..
.10 ومنها: ذكر ما يطمئن به العبد حين يخشى أن يقلق فكره؛ لقوله تعالى: ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها )
القـرآن
)أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ) (البقرة:107)
التفسير:
.{ 107 } قوله تعالى: { ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض } أي أن الله وحده الذي له ملك السموات، والأرض: ملك الأعيان، والأوصاف، والتدبير؛ فأعيان السموات، والأرض، وأوصافها ملك لله؛ و"التدبير" يعني أنه تعالى يملك التدبير فيها كما يشاء: لا معارض له، ولا ممانع؛ و{ السموات } جمع سماء؛ ويُطلق على العلو، وعلى السقف المحفوظ . وهو المراد هنا .؛ وهي سبع سموات كما جاء في القرآن الكريم، والسنة النبوية؛ و{ الأرض } أي جنس الأرضين، فيشمل السبع كلها..
قوله تعالى: { وما لكم من دون الله } أي من سواه؛ { من ولي }: فعيل بمعنى مفعل؛ أي ما من أحد يتولاكم فيجلب لكم الخير؛ { ولا نصير } أي ولا ناصر يدفع عنكم الشر؛ و{ مِن }: حرف جر زائد إعراباً؛ ولكنه أصلي المعنى؛ إذ إن الغرض منه التنصيص على العموم؛ يعني ما لكم أيّ ولي..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: تقرير عموم ملك الله؛ لقوله تعالى: { ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض }؛ ولا يرد على هذا إضافة الملك للإنسان، كما في قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] ؛ فإن هذه الإضافة ليست على سبيل الإطلاق؛ لأن ملك الإنسان للأشياء ملك محدود، وناقص، وقاصر؛ محدود من حين استيلائه عليه إلى أن يخرج عن ملكه ببيع، أو هبة، أو موت، أو غير ذلك؛ كذلك هو ناقص: فهو لا يملك التصرف فيه كما يشاء؛ بل تصرفه مقيد بما يباح له شرعاً؛ ولهذا لو أراد أن يحرق ملكه لم يملك ذلك؛ كذلك أيضاً ملك الإنسان قاصر؛ فهو لا يملك إلا ما تحت يده؛ فلا يشمل ملك الآخرين..
.2 ومن فوائد الآية: اختصاص ملك السموات، والأرض بالله؛ وهذا مأخوذ من تقديم الخبر، حيث إن تقديم الخبر يدل على الحصر؛ لقوله تعالى: { له ملك السموات والأرض }..
.3 ومنها: أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاء، ويثبت؛ فكأن قوله تعالى: { ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض } تعليل لقوله تعالى: { ما ننسخ من آية }؛ فالمالك للسموات والأرض يتصرف فيهما كما شاء..
.4 ومنها: أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءاً؛ لقوله تعالى: { وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
.5 ومنها: أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية، والنصر..
فإذا قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى يقول: {هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين} [الأنفال: 62] ، ويقول تعالى: {إلا تنصروه فقد نصره الله} [التوبة: 40] ؛ فأثبت نصراً لغير الله..
فالجواب: أن إثبات النصر لغير الله إثبات للسبب فقط؛ وليس نصراً مستقلاً؛ والنصر المستقل من عند الله؛ أما انتصار بعضنا ببعض فإنه من باب الأخذ بالأسباب؛ وليس على وجه الاستقلال..
.6 ومن فوائد الآية: أن ما يريده الإنسان فهو إما جلب منفعة يحتاج إلى ولي يجلبها له؛ وإما دفع مضرة يحتاج إلى نصير يدفعها عنه..
القـرآن
)أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ) (البقرة:108)
التفسير:
.{ 108 } قوله تعالى: { أم تريدون أن تسألوا }؛ { أم } هنا منقطعة بمعنى "بل" وهمزة الاستفهام؛ أي: بل أتريدون؛ والإضراب هنا ليس للإبطال؛ لأن الأول ليس بباطل؛ بل هو باق؛ فالإضراب هنا إضراب انتقال؛ و "الإرادة" هنا بمعنى المشيئة؛ وإن شئت فقل: بمعنى المحبة؛ والخطاب هنا قيل: إنه لليهود حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات يأتي بها؛ وقيل: إنه للمشركين؛ لقوله تعالى: {وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً} [الإسراء: 90] ؛ وقيل: إنه للمسلمين؛ والآية صالحة للأقوال كلها؛ لأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول للجميع؛ لكن تخصيصها باليهود يبعده قوله تعالى: { كما سئل موسى من قبل }؛ فمعنى الآية: أتريدون أن توردوا الأسئلة على رسولكم كما كان بنو إسرائيل تورد الأسئلة على رسولها؛ ولا شك أن الاستفهام هنا يراد به الإنكار على من يكثرون السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم..
قوله تعالى: { رسولكم }: أضافه سبحانه وتعالى إليهم، مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه: {يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم} [المائدة: 15] ؛ والجمع بين ذلك: أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال: فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله؛ ورسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا؛ والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع..
قوله تعالى: { كما سئل موسى من قبل } أي كما سأل بنو إسرائيل موسى من قبل، كقولهم: {لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة} [البقرة: 55] ، وقولهم: {اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة} [الأعراف: 138] ، وغير ذلك؛ فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة، والتعنت، والإعجاز؛ أما هذه الأمة فإنها قد أدَّبها الله عز وجل فأحسن تأديبها: لا يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة..
قوله تعالى: { ومن يتبدل الكفر بالإيمان } أي يأخذ الكفر بديلاً عن الإيمان؛ { فقد ضل } أي تاه { سواء السبيل } أي وسط الطريق؛ يعني يخرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق، وإلى شعبها؛ وطريق الله واحد؛ وعليك أن تمشي في سواء الصراط . أي وسطه . حتى لا تعرض نفسك للضلال..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: إنكار كثرة الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الاستفهام: { أم تريدون } يقصد به الإنكار؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذراً من ذلك: "ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم"(163) ؛ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرَّم فحُرِّم من أجل مسألته"(164) ؛ فهذا نهي، وإنكار على الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل؛ والمطلوب من المسلم في زمن الوحي أن يسكت حتى ينزل ما أراد الله عز وجل من أمر أو نهي..
.2 ومن فوائد الآية: تأكيد ذم هذا النوع من الأسئلة؛ لقوله تعالى: { رسولكم }؛ فكأنه أراد أنه لما كان رسولكم، فالذي ينبغي منكم عدم إعناته بالأسئلة..
.3 ومنها: أن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم من مصالحنا، ومنافعنا؛ لقوله تعالى: ( رسولكم )..
.4 ومنها: أن كثرة الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها مشابهة لليهود؛ لقوله تعالى: ( كما سئل موسى من قبل).
.5 ومنها: أنه لا ينبغي إلقاء السؤال إلا لمصلحة: إما رجل وقعت له مسألة يسأل عن حكمها؛ أو طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصولها؛ أما الأسئلة لمجرد استظهار ما عند الإنسان فقط؛ أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وما أشبه ذلك؛ أو لأجل إعنات المسؤول، وإحراجه؛ فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا تنبغي..
.6 ومن فوائد الآية: ذم بني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في هذه الآية على سبيل الذم..
.7 ومنها: أن اليهود كانوا سألوا موسى عن أشياء فكانت العاقبة فيها وخيمة: فقد سألوا عن أشياء بينت لهم؛ لكنهم لم يعملوا بها؛ فكانت نتيجة السؤال الخيبة..
.8 ومنها: إثبات رسالة موسى صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: { كما سئل موسى من قبل } يعني: وهو رسول..
.9 ومنها: ذم من استبدل الكفر بالإيمان؛ لقوله تعالى: { ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ؛ وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه، ومن ارتد بعد إيمانه؛ فإنه في الحقيقة تبديل؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة؛ فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان..
.10 ومنها: أن من اختار الكفر على الإيمان فهو ضال..
.11ومنها: عكس هذه المسألة: أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هُدي إلى سواء السبيل..
.12 ومنها: الرد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة في عمله، وأنه مجبر عليه؛ لقوله تعالى: { ومن يتبدل الكفر بالإيمان }..
.13 ومنها: أنه يجب على السائل أن يعمل بما أجيب به؛ لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان من بعد ما تبين له أنكر؛ فالواجب على المرء إذا سأل من يثق به أن يعمل بقوله؛ ولهذا قال العلماء: ومن سأل مفتياً ملتزماً بقوله حرم عليه أن يسأل غيره؛ لأنه حين سأله كان يعتقد أن الذي يقوله هو الشرع؛ فإذا كان يعتقد هذا فلا يسأل غيره؛ نعم، إذا سأل إنساناً يثق به بناءً على أن فتواه هو الشرع، وأفتاه، ولكنه سمع في مجلس عالم آخر حكماً نقيض الذي أُفتي به مدعَّماً بالأدلة، فحينئذ له أن ينتقل؛ بل يجب عليه؛ أو سأل عالماً مقتنعاً بقوله للضرورة . لأنه ليس عنده في البلد أعلم منه . على نية أنه إذا وجد أعلم منه سأله؛ فهذا أيضاً يجوز أن يسأل غيره إذا وجد أعلم منه..
القـرآن
)وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة:109)
التفسير:
.{ 109 } قوله تعالى: { ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً }؛ { ود } بمعنى أحب؛ بل إن "الود" خالص المحبة؛ والمعنى: أن كثيراً من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم أن يردوكم كفاراً؛ أي يرجعوكم كفاراً؛ وعلى هذا فـ{ يردونكم } تنصب مفعولين؛ الأول: الكاف في { يردونكم }؛ والثاني: { كفاراً }؛ و{ أهل الكتاب } هم اليهود، والنصارى؛ والمراد بـ{ الكتاب } التوراة، والإنجيل؛ و{ لو } هنا مصدرية؛ وضابطها أن تقع بعد "ود" ونحوها؛ و{ من بعد إيمانكم } أي من بعد أن ثبت الإيمان في قلوبكم..
قوله تعالى: { حسداً } مفعول لأجله عامله: { ود }؛ أي ودوا من أجل الحسد؛ يعني هذا الود لا لشيء سوى الحسد؛ لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة؛ وهؤلاء الكفار أعداء؛ والعدو يحسد عدوه على ما حصل له من نعمة الله؛ و "الحسد" تمني زوال نعمة الله على الغير سواء تمنى أن تكون له، أو لغيره، أو لا لأحد؛ فمن تمنى ذلك فهو الحاسد؛ وقيل: "الحسد" كراهة نعمة الله على الغير..
قوله تعالى: { من عند أنفسهم } أي هذه المودة التي يودونها ليست لله، ولا من الله؛ ولكن من عند أنفسهم..
قوله تعالى: { من بعد ما تبين } أي من بعد ما ظهر { لهم } أي لهؤلاء الكثيرين؛ { الحق } أي ما أنتم عليه من الحق؛ و "الحق" هو الشيء الثابت؛ فإن وصف به الحكم فالمراد به العدل؛ وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق؛ فـ{ الحق } الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام؛ ودين الإسلام على هذا؛ وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا؛ فإن أخباره صدق، وأحكامه عدل..
قوله تعالى: { فاعفوا واصفحوا }: الخطاب للمؤمنين عامة؛ ويدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم؛ و "العفو" بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب؛ كأنه من عفا الأثر: إذا زال لتقادمه؛ و{ اصفحوا }: قيل: إنه من باب عطف المترادفين، كقول الشاعر:
(فألفى قولها كذباً وميناً) و"الكذب" و"المين" معناهما واحد؛ ولكن الصواب أن بين "العفو" ، و "الصفح" فرقاً؛ فـ "العفو" ترك المؤاخذة على الذنب؛ و "الصفح" الإعراض عنه؛ مأخوذ من صفحة العنق؛ وهو أن الإنسان يلتفت، ولا كأن شيئاً صار . يوليه صفحة عنقه .؛ فـ "الصفح" معناه الإعراض عن هذا بالكلية وكأنه لم يكن؛ فعلى هذا يكون بينهما فرق؛ فـ "الصفح" أكمل إذا اقترن بـ "العفْو" ..
قوله تعالى: { حتى يأتي الله بأمره } أي بأمر سوى ذلك؛ وهو الأمر بالقتال..
قوله تعالى: { إن الله على كل شيء قدير } أي لا يعتريه عجز في كل شيء فعله..
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: بيان شدة عداوة اليهود، والنصارى للأمة الإسلامية؛ وجه ذلك أن كثيراً منهم يودون أن يردوا المسلمين كفاراً حسداً من عند أنفسهم..
.2 ومنها: أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة؛ لقوله تعالى: { لو يردونكم }؛ ولهذا الذي يكفر بعد الإسلام لا يسمى باسم الدين الذي ارتد إليه؛ فلو ارتد عن الإسلام إلى اليهودية، أو النصرانية لم يعط حكم اليهود، والنصارى..
.3 ومنها: أن الحسد من صفات اليهود، والنصارى..
.4 ومنها: تحريم الحسد؛ لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم"(165) ؛ واعلم أن الواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن يسأل الله من فضله، ولا يكره ما أنعم الله به على الآخرين، أو يتمنى زواله؛ لقوله تعالى: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله} [النساء: 32] ؛ والحاسد لا يزداد بحسده إلا ناراً تتلظى في جوفه؛ وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة؛ فهو مع كونه كارهاً لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه؛ لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود؛ ثم إن الحاسد أو الحسود . مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلاً فيها؛ لأنه لابد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه، فيحتقر النعمة؛ حتى لو فرضنا أنه تميز بأموال كثيرة، وجاء إنسان تاجر، وكسب مكسباً كبيراً في سلعة معينة تجد هذا الحاسد يحسده على هذا المكسب بينما عنده ملايين كثيرة؛ وكذلك أيضاً بالنسبة للعلم: بعض الحاسدين إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم تجده . وإن كان أعلم منه . يحسده على ما برز به؛ وهذا يستلزم أن يحتقر نعمة الله عليه؛ فالحسد أمره عظيم، وعاقبته وخيمة؛ والناس في خير، والحسود في شر: يتتبع نعم الله على العباد؛ وكلما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه؛ ولو لم يكن من خُلُق الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافياً في النفور منه..
.5 ومن فوائد الآية: علم اليهود، والنصارى أن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه؛ لقوله تعالى: { حسداً }؛ لأن الإنسان لا يحسد إلا على شيء يكون خيراً، ومنقبة؛ ويدل لذلك قوله تعالى: {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم} [البقرة: 105] ..
.6 ومنها: وجوب الحذر من اليهود، والنصارى؛ ما دام كثير منهم يودون لنا هذا فإنه يجب علينا أن نحذر منهم..
.7 ومنها: بيان خبث طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر؛ لقوله تعالى: { من عند أنفسهم }؛ ليس من كتاب، ولا من إساءة المسلمين إليهم؛ ولكنه من عند أنفسهم: أنفس خبيثة تود الكفر للمسلمين حسداً..
.8 ومنها: أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين لهم الحق؛ فلو كانوا جاهلين بأن المسلمين على حق، وقالوا: "لا نريد أن نكون على دين مشكوك فيه" لكان لهم بعض العذر؛ ولكنهم قد تبين لهم الحق، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن دينه حق، وأن المؤمنين على حق؛ ومع ذلك فهم يودون هذه المودة، ويسعون بكل سبيل أن يصلوا إلى غايتهم؛ فمن أحب شيئاً سعى في تحصيله؛ فكثير من هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية، أو أخلاقية، أو غيرهما ليردوا المسلمين بعد الإيمان كفاراً..
.9 ومن فوائد الآية: مراعاة الأحوال، وتطور الشريعة، حيث قال تعالى: { فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره }..
.10 ومنها: أن الذم إنما يقع على من تبين له الحق؛ وأما الجاهل فهو معذور بجهله إذا لم يقصر في طلب العلم..
11 . ومنها: جواز مهادنة الكفار إذا لم يكن للمسلمين قوة..
.12 ومنها: إثبات الحكمة لله عز وجل، حيث أمر بالعفو، والصفح إلى أن يأتي الله بأمره؛ لأن الأمر بالقتال قبل وجود أسبابه، وتوفر شروطه من القوة المادية والبشرية، ينافي الحكمة..
.13 ومنها: الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل؛ والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد فعلاً يليق بجلاله وعظمته، وما تقتضيه حكمته؛ لقوله تعالى: { حتى يأتي الله بأمره }..
.14 ومنها: ثبوت القدرة لله عز وجل، وأنها شاملة لكل شيء؛ لقوله تعالى: ( إن الله على كل شيء قدير )
.15 ومنها: الرد على المعتزلة القدرية؛ لأنهم يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله؛ وإذا كان مستقلاً بعمله لزم من ذلك أن الله لا يقدر على تغييره؛ لأنه إن قدر على تغييره صار العبد غير مستقل..
.16 ومنها: بشارة المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سيغير حالهم المقتضية للعفو والصفح، إلى قوة يستطيعون بها جهاد العدو..
.17 ومنها: اتباع الحكمة في الدعوة إلى الله بالصبر، والمصابرة حتى يتحقق النصر، وأنْ تعامَل كل حال بما يناسبها..
القـرآن
)وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة:110)
التفسير:
.{ 110 } قوله تعالى: { وأقيموا الصلاة } يعني أدوا الصلاة على وجه الكمال؛ لأن إقامة الشيء جعله قيماً معتدلاً مستقيماً؛ فمعنى { أقيموا الصلاة } أي ائتوا بها كاملة بشروطها، وواجباتها، وأركانها، ومكملاتها.
قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} أي أعطوها؛ وهنا حذف المفعول الثاني؛ والتقدير: وآتوا الزكاة مستحقيها؛ و{ الزكاة } المفعول الأول؛ ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء...} إلخ [التوبة: 60] ..
و"الزكاة" في اللغة النماء، والزيادة؛ ومنه قولهم: "زكا الزرع" إذا نما، وزاد؛ وفي الشرع هي دفع مال مخصوص لطائفة مخصوصة تعبداً لله عز وجل؛ وسميت زكاة؛ لأنها تزكي الإنسان، كما قال الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] ؛ فهي تزكي الإنسان في أخلاقه، وعقيدته، وتطهره من الرذائل؛ لأنها تخرجه من حظيرة البخلاء إلى حظيرة الأجواد، والكرماء؛ وتكفِّر سيئاته..
قوله تعالى: { وما تقدموا لأنفسكم }؛ { ما } شرطية؛ لأنها جزمت فعل الشرط، وجوابه..
قوله تعالى: { من خير } يشمل ما يقدمه من المال، والأعمال؛ وهو بيان للمبهم في اسم الشرط..
ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى: {مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء} [البقرة: 261].
قوله تعالى: { إن الله بما تعملون بصير }؛ هذه الجملة مؤكدة بـ{ إن } مع أن الخطاب ابتدائي؛ إذ إنه لم يوجه إلى متردد، ولا منكر؛ والخطاب إذا لم يوجه لمنكر، ولا متردد فإنه يسمى ابتدائياً؛ والابتدائي لا يؤكد؛ لأنه لا حاجة لذلك؛ ولكنه قد يؤكد لا باعتبار حال المخاطب؛ لكن باعتبار أهمية مدلوله؛ فهنا له أهمية عظيمة: أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه بكل ما نعمل بصير؛ و{ ما } اسم موصول يفيد العموم؛ أي بما نعمل قلبياً، وبدنياً؛ قولياً، وفعلياً؛ لأن القلوب لها أعمال كالمحبة، والخوف، والرجاء، والرغبة، وما أشبه ذلك؛ و{ بما تعملون } متعلقة بـ{ بصير }؛ وقدمت عليها لغرضين؛ الأول: مراعاة الفواصل؛ لأن التي قبلها فاصلة بالراء: { قدير }، وبعدها: { بصير }؛ والثاني: من أجل الحصر؛ والحصر هنا وإن كان يقلل من العموم لكنه يفيد الترهيب والترغيب؛ لأنه إذا قيل: أيهما أعظم في التهديد أو الترغيب، أن نقول: إن الله بصير بكل شيء مما نعمل، ومما لا نعمل؛ أو أنه بصير بما نعمل فقط؟
فالجواب: أن الأول أعم؛ والثاني أبلغ في التهديد، أو الترغيب؛ وهو المناسب هنا؛ كأنه يقول: لو لم يكن الله بصيراً إلا بأعمالكم فإنه كاف في ردعكم، وامتثالكم؛ و{ بصير } ليس من البصر الذي هو الرؤية؛ لكن من البصر الذي بمعنى العلم؛ لأنه أشمل حيث يعم العمل القلبي، والبدني؛ والعمل القلبي لا يدرك بالرؤية.
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: وجوب إقامة الصلاة؛ والصلاة تشمل الفريضة والنافلة؛ ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل؛ لأنه جاء في الحديث(166) أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة؛ ما من إنسان إلا وفي فريضته نقص؛ لكن هذه النوافل تكملها، وترقعها..
.2 ومنها: وجوب إيتاء الزكاة . يعني لمستحقيها ...
.3 ومنها: أن الصلاة أوكد من الزكاة؛ ولهذا يقدمها الله عليها في الذكر..
.4 ومنها: أن إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة من أسباب النصر؛ لأن الله ذكرها بعد قوله: {فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره} [البقرة: 109] ؛ وقد جاء ذلك صريحاً في قوله تعالى: {ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز * الذين إن مكنَّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور} [الحج: 40، 41] ..
.5 ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بالأهم فالأهم مع الدعوة إلى الله عز وجل..
.6 ومنها: أن كل خير يقدمه العبد لربه عز وجل فإنه سيجد ثوابه عنده..
.7 ومنها: أن الثواب عام لجميع الأعمال صغيرها، وكبيرها؛ لقوله تعالى: { من خير }؛ فإنها نكرة في سياق الشرط؛ فتفيد العموم؛ فأيّ خير قدمته قليلاً كان، أو كثيراً ستجد ثوابه؛ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"(167) ..
.8 ومنها: الترغيب في فعل الخير، حيث إن الإنسان يجد ثوابه عند ربه مدخراً له . وهو أحوج ما يكون إليه ...
.9 ومنها: أن الإنسان إذا قدم خيراً فإنما يقدمه لنفسه؛ لقوله تعالى: { وما تقدموا لأنفسكم من خير }؛ ولهذا ليس له من ماله إلا ما أنفق لله؛ وما أخره فلوارثه..
.10 ومنها: عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل..
.11 ومنها: التحذير من المخالفة؛ لقوله تعالى: ( إن الله بما تعملون بصير )
القـرآن
)وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (البقرة:111)
التفسير:
.{ 111 } قوله تعالى: { وقالوا } أي اليهود، والنصارى؛ { لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً }: هذا قول اليهود؛ { أو نصارى }: هذا قول النصارى..
قوله تعالى: { تلك أمانيهم } أي تلك المقالة؛ و{ أمانيهم } جمع أمنية؛ وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه..
قوله تعالى: { قل } أي يا محمد؛ { هاتوا }: فعل أمر؛ لأن ما دل على الطلب، ولحقته العلامة فهو فعل أمر؛ يقال: "هاتي" للمرأة؛ "هاتيا" للاثنين؛ والأمر هنا للتحدي، والتعجيز؛ { برهانكم } أي دليلكم؛ مِن "برهن على الشيء": إذا بينه؛ أو من "بَرَه الشيء": إذا وضح بالعلامة؛ فعلى الأول تكون النون أصلية؛ وعلى الثاني تكون النون زائدة؛ وعلى القولين جميعاً فـ "البرهان" هو الذي يتبين به حجة الخصم؛ يعني ما نقبل كلامكم إلا إذا أقمتم عليه الدليل؛ فإذا أقمتم عليه الدليل فهو على العين، والرأس..
قوله تعالى: { إن كنتم صادقين } يعني أن هذا أمر لا يمكن وقوعه؛ فهو تحدٍّ، كقوله تعالى: {فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم} [البقرة: 94، 95] ؛ فإذا كانوا صادقين في زعمهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً، أو نصارى فليأتوا بالبرهان؛ ولن يأتوا به؛ إذاً يكونون كاذبين.
الفوائد:
.1 من فوائد الآية: بيان ما كان عليه اليهود، والنصارى من الإعجاب بما هم عليه من الدين..
.2 ومنها: تعصب اليهود، والنصارى؛ وتحجيرهم لفضل الله..
.3 ومنها: أن ما ادعوه كذب؛ لقوله تعالى: { تلك أمانيهم }؛ فعلى قول هؤلاء اليهود يكون النصارى، والمسلمون لن يدخلوا الجنة؛ وقد سبق أن قالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ثم تخلفوننا فيها؛ وعلى قول النصارى لا يدخل اليهود، ولا المسلمون الجنة؛ أما اليهود فصحيح: فإنهم كفروا بعيسى، وبمحمد؛ ومن كفر بهما فإنه لن يدخل الجنة؛ وأما بالنسبة للمسلمين فغير صحيح؛ بل المسلمون هم أهل الجنة؛ وأما اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أهل النار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار"(168) ؛ فالحاصل أن هذا القول . وهو قولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى . كذب من الطرفين؛ ولهذا قال تعالى: { تلك أمانيهم }؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الكيِّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني(169)" ..
.4 ومن فوائد الآية: أن من اغتر بالأماني، وطمع في المنازل العالية بدون عمل لها ففيه شَبه من اليهود، والنصارى..
.5 ومنها: عدل الله عز وجل في مخاطبة عباده، حيث قال تعالى: { قل هاتوا برهانكم }؛ لأن هذا من باب مراعاة الخصم، وأنه إن كان لكم بينة فهاتوها؛ وهذا لا شك من أبلغ ما يكون من العدل؛ وإلا فالحكم لله العلي الكبير..
.6 ومنها: أن هؤلاء لا برهان لهم على ما ادعَوه بدليل أنهم لم يأتوا به..
.7 ومنها: أنهم كاذبون؛ لقوله تعالى: { إن كنتم صادقين }؛ ولو كان لهم أدنى حيلة بما يبرر قولهم، ويصدِّقه لأتوا بها..